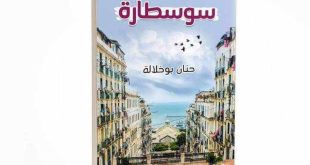إخضاع النص للفضاء الثقافي في رواية «موت صغير»

سمير الخليل/ ناقد وأكاديمي من العراق
صحيفة القدس العربي
10 – أغسطس – 2020
تصدرت رواية «موت صغير» الصادرة عن دار الساقي – بيروت 2017 والفائزة بجائزة البوكر لعام 2017 للروائي السعودي محمد حسين علوان لسرد السيرة الذاتية للمتصوف الأندلسي محيي الدين بن عربي (558-638هـ) (1165-1240م). وقد وفق الروائي إلى حد كبير في مسعاه مستعينا بعشرات المصادر التأريخية، التي تعرضت لحياة ابن عربي من المولد حتى الممات، والبيئة التي عاش فيها طفولته وصباه وشبابه، ثم تنقلاته في أصقاع الوطن العربي طولا وعرضا. وعالجت طبيعة تلمذته الأولى وتلقي معارفه البدئية على أيدي شيوخ كبار وعلماء مشهورين، ثم سردا ثمينا عن قراءاته الفكرية والفقهية والفلسفية، وتطلعاته وآماله الكبيرة في تبؤ مهمة في نظام العقل العربي- الإسلامي، وفي الأنظمة المعرفية العالمية.
استطاع المؤلف بلغته التواصلية السهلة فرش مشاهد خلابة لما كانت عليه الحياة في المدن والبلدان الأندلسية والمغاربية، وامتدادتها إلى باقي الجغرافيا العربية المترامية الأطراف، مخضعا نصّه لما يتوقعه القارئ من مثل مرويات كهذه. ويعني إخضاع النص منحه مكانة في الفضاء الذي تحدده ثقافتنا، وهذا معناه إدماج النص في السياق الثقافي العام. وكذلك صهره بالمزاج القرائي السائد. إن دمج النص أو تأويله (ترويضه) معناه سحبه إلى حاضنة النظام المعرفي الذي توفره الثقافة. والإخضاع يعني أكثر من معرفة أو إدراك لموضوع مألوف أو موضوع لا يخرق ألفه القارئ الذي يمتلك بعض الأوليات عن الموضوع، الذي يراد إخضاعه، فهو لا يتطلب جهدا قرائيا أكثر من أن ينطق القارئ بذلك الإدراك بلغته الخاصة، وهذا يعني أن قراءة السيرة الغيرية الخاصة بشخصية معروفة، حتى إن شابتها بعض الإزاحات الأدبية وبعض الضرورات الحكائية، تنطوي على المزيد من المسلّمات المفيدة التي تحف بنوعية الإدراك للفهم المشترك والتأريخ المعمم.
وتأسيسا على ذلك، تشتغل عملية التبادل، أو التقابل لتوليد علاقة تداولية بين الرواية والواقع من جهة، والرواية والقارئ الفاعل من جهة أخرى. وبهذا تتكون حلقة وصل بين النص السردي البحت، والعلامات المجازية للخطاب الثقافي المرتبط بأفاق الثقافة السابحة في الفضاء العام. ولهذا السبب لا يمكن قراءة هذه الرواية الضخمة (حوالي 600 صفحة) إلا من حيث صلتها بالحاضر القرائي واختلافها عنه، فهذه الصلة هي التي توفر أرضية جدلية وحوارية يعرف من خلالها المعنى العام للرواية، والهدف الأوحد للمؤلف، والذرائع البراغماتية التي يمكن أن نسوقها أو يسوقها المؤلف لقراءة مثل هذه الأعمال الاستعادية. ولأن النقاش المثمر ينبغي أن يتمحور حول الأثر الدلالي للرواية وليس حول الأثر الشكلي المحسوم، بسيمتريته المتقدمة بخط واحد من البداية إلى النهاية، لصياغة الصورة النهائية لاستعادة الأصل التكويني، لكن الأثر الدلالي أوصلنا إلى عدم اليقين في استعادة الأصل التكويني في نهاية الأمر.
فالأثر الدلالي بحكم تعريفه وتأثيره وتصادياته لدى القراء المعاصرين، لا يمكن تشخيصه على أنه تركيب ثقافي اعتباطي وزائف. ولا بد للأثر الدلالي أن يرتهن للسائدية الراهنة، وأن يؤتى به إلى دائرة اهتمامنا وترجيعات قلقنا وصداعنا وتوجساتنا، إذا أردنا أن لا نظل حائرين أمام خيارات عافها الزمن وتجاوزتها الرهانات والأولويات الوجودية والواقعية المستجدة، وتخطتها عجلة التطور العلمي والتقاني والثقافي.
تتقدم الرواية على حساب انحسار اهتمامنا بمتابعتها، فليس منطقيا أن نلبس جبّة الصوف في هذا الحر القاتل المقيم في وطننا لثلاثة أرباع السنة. وليس منطقيا أن نتعامل مع الحياة بوصفها «موتا صغيرا» والموت بوصفه «حياة كبيرة» لأن «كل بقاء يكون بعده فناء لا يعوّل عليه» كما يقول ابن عربي.
إن وعي الذات، لاسيما على المستوى الثقافي، ليس بالشيء الذي يستخف به، أو يتلاعب به، أو يمكن تجنبه، أو أهماله، أو تسطيحه. إن المساهمة في إنضاج وعي الذات هي مهمة الإبداع النبيلة، ولأجل وضع النقاط على الحروف، وصناعة أسئلة ثقافية لها مساس براهننا العولمي- الفوضوي، ليس أمامنا إلا أن نطرح استفهاماتنا في ضوء قراءتنا للرواية:
هل نحن في حاجة لاستعادة تجربة ابن عربي الحياتية والصوفية الآن- هنا؟
هل نحن في حاجة إلى التصوف وأحوال ومقامات الصوفية، وما يرافقها من شطح وقبض وبسط وجذب، وأوهام وأخيولات واستيهامات سمعية وبصرية، وخلوة وبكاء وصيام متواصل وتقشف قاتل، وتعذيب للجسد وترويض للحواس وإعدام للقدرات الإبداعية، وما إلى ذلك من دروشات وتشنجات مرضية وعرفانيات، تؤدي إلى الخمول والكسل وانتظار أعطيات الآخرين من كرماء القوم، أو انتظار مكرمات متنفذي السلطة القابضين على كل الأرزاق وقد بهرتهم ألاعيب الدروشة لبعض الوقت؟
ألم يحسم الاختيار بعد بين العقل العلمي والعقل الصوفي الخرافي، ونحن في خضم القرن الواحد والعشرين؟ هل استطاع العقل الصوفي (والسلفي عموما) وبكل ادعاءاته وتخرصاته وترهاته، أن ينتج قمحا أو يولّد كهرباء أو يخترع علاجا لأي مرض؟ هل بمقدور العقل الصوفي أن يطور حياتنا أو يوسع أحلامنا الوجودية، أو يثري ثقافتنا، أو يساهم ولو مساهمة متواضعة في تعزيز مدنيتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الأهلي؟ هل صاغ العقل الصوفي طيلة تأريخه الطويل قانونا واحدا يمكن أن نضيفه إلى قوانيننا النافذة في أي شأن من شؤون واقعنا المملوء بالانسدادت والمآزق والأزمات؟
ولنبحث عن الأثر الدلالي الضائع في النصين الآتيين، كما نتبين مدى علاقة الرواية بنا وبالواقع الذي نعيش فيه، ومدى قدرة الروائي على تطبيع الرواية مع أسئلة الحاضر. «وعلى مثل هذه الحال التي يكون فيها القلب مفتوحا على مهبّ الجهات الأربع، أفاض الله عليّ من علمه اللدنيّ معارج عقلية ما صعدتها من قبل، ومقامات روحانية ما بلغتها قط، ومراتب عليّة أضاءت طريقي مثلما تضيء الشمس أرجاء الكون. وسرعان ما شعر بي الأولياء وأهل الطريق. يفدون إلى بستان ابن حيوّن في اجتماع ليس فيه إلاّ ولي مجتبى، قد بلغ في الطريق مقاما عاليا. خلونا ببعضنا أسابيع لم نحصها. طلعت علينا شمس غير شمس العالمين، وأضاء ليالينا بدر مكتمل لا ينقص طيلة الشهر. إذا كشف أيّ منا سرا قدسيا شق السماء فوقنا شهاب ساطع. وإذا تحدث أحدنا باللطائف العلوية نزلت معنا نجمة أو نجمتان. وإذا تلّقى أحدنا نفثا روحانيا قبضنا على يديه ليسري في أرواحنا ما يسري فيه. ارتدى كل منا خرقة الآخر والتقت القلوب والأرواح قبل الأجساد والأبدان وعدنا إلى الناس، وكلّ منا في مقام جديد لم يقم فيه من قبل». «لا مفر لي الآن إلا المقبرة. عدت إليها مرة أخرى لعلي أهذب هذه الروح حتى تكون أهلا لجذبة الله. كلما غابت الشمس دخلتها مثل ميّت يمشي على قدميه وجلست فيها وحدي حتى يقترب الفجر. وفي كل ليلة منها أسأل الله أن يبارك لي في خلوتي ويمنحني حضرته وأن يطهر قلبي ويرزقني الصمت والجوع والتوكل. آنس بحضرتي الموتى تدريجيا وتحدثنا عن الموت والبرازخ والمقامات والعالم الآخر. ومرّت أشهر ستة كأنها ستة أيام من لذة عزلتي وسكينة خلوتي. لا يطربني إلاّ أذان المغرب الذي يعلن موعد دخولي إلى المقبرة ولا تحزنني إلا خيوط الفجر التي تطردني منها. وفي ليلة من تلك الليالي لي شعرت بحركة من حركات الأحياء في المقبرة، وقفت فاذا بالكوميّ يسعى نحوي وهو متكئ على عصاه. سلّمت عليه مندهشا وأنا لا أعرف كيف وجدني. أفسحت له مكانا فجلس وأطرق صامتا يستشعر جلال المكان وطمأنينته، ثم قال: هنيئا لك مجالسة الأحياء في المقبرة. أما الناس خارجها فموتى ولكن لا يشعرون. هل تأذن لي بمرافقتك؟ بل تزيدني بركات وهدى إن رافقتني يا شيخي. ورافقت الكوميّ في المقبرة ستا وسبعين ليلة لم ننقطع فيها عن المقبرة ساعة واحدة منذ غروب الشمس حتى طلوع الصبح. نسبحّ تارة ونقرأ تارة ونتأمل تارة».
وعلى هذا المنوال تتقدم الرواية على حساب انحسار اهتمامنا بمتابعتها، فليس منطقيا أن نلبس جبّة الصوف في هذا الحر القاتل المقيم في وطننا لثلاثة أرباع السنة. وليس منطقيا أن نتعامل مع الحياة بوصفها «موتا صغيرا» والموت بوصفه «حياة كبيرة» لأن «كل بقاء يكون بعده فناء لا يعوّل عليه» كما يقول ابن عربي.
ومن هذا العنوان، ومن تلك الحكمة، لم نستطع أن نهتدي إلى أي أثر دلالي يثري حياتنا التي لا تحتاج إلى المزيد من البؤس واليأس والضحك على الذقون.
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني