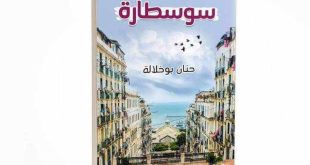الطقوس الكورالية للرواية

متى فقد الإنسان كماله الذي هو يمثل سعادته؟ أ بعد أن تكشفت له عورته وتعرف على غرائزه أم بعد أن وقف على قائمتيه الخلفيتين وبدأ يفكر؟
أعتقد أن هذا السؤال هو الذي قاد الإنسان إلى الشعر ومن بعده إلى الرواية، وليدته الأوسع في الطرح والمعالجة والتشخيص وتكثيّر زوايا النظر.
وإذا كان الشعر وسيلة تعبير الإنسان الأولى عن حاجته للكمال، فإن الرواية أخذت على عاتقها مسؤولية طرح تلك الحاجة كإشكالية ومد الصلات بينها وبين جذور صيّغها الفلسفية.
جاءت الرواية لتشخص وتؤطر حدود إشكالية ضعف الإنسان وإنحجاب الرؤية عنه وتمترسها خلف أسوار غير مفهومة، وأيضا كون أن هذه الأسوار أكثر فسادا في سبل تمظهرها وتعاطيها مع فساد الإنسان وضعفه، في بناه الفسلجية والبايلوجية وليس الأخلاقية أو القيمية طبعا.
وأمام هذا الضعف المستديم (في كون الإنسان محكوم بالهرم والتداعي والفناء) لم يجد أمامه من سلاح غير السؤال والشك الضروريان، وأيضا البحث المستبطن ـ الميتافيزيقي في البحث عن متسع للنظر وإيجاد البدائل ومراحات الإختبار ـ وهذا هو ما تولته الرواية وطاردته في غابات الضياع، وتركت مهمة تصنيفه وتبويبه، منهجيا وإصطلاحيا، للفلاسفة المحضين والدارسين المكتبيين.
الحلقة التي نالت النصيب الأوفر من جهد الرواية البحثي تمثلت في السؤال التالي: كم خسرنا من حقيقة وجودنا وفاعليته وغايته ومراحاته (الدنيوية) بخسارتنا (لسعادتنا الحيوانية)؟ وبصياغة أكثر تركيزا: هل ما ضحينا به من بساطة (ربما بساطة زوربا اليوناني هي المثال الأنصع هنا) وسعادة فطرية كافئه ما حصلنا عليه من (عذاب ميتافيزيقي) بتعبير أحد روائيي أمريكا اللاتينية؟
وإذا كانت الفلسفة قد بحثت عن حلول وتفسيرات (وهي التي قادت البشرية في النهاية إلى الرياضيات وعلوم الطبيعة ومنجزات الثورة الصناعية) فإن الرواية إكتفت بالعرض وتهيئة المراحات للتفسير: أنا موجود إذا من حقي طرح السؤال؛ وأنا أطرح السؤال، إذا أنا موجود!، وهذا التفسير كان إشاريا أو بمستوى الطقسية الكورالية، إذا جاز لنا التشبيه: طقوس عرض لا طقوس واجبات.
وأمام الحالة الإنتقالية التي يعيشها الإنسان، وتعاظم حدة تأثير هذه الإنتقالية على مساحة سعادته وراحته النفسية، لجأت الرواية للبحث عن صيغ تفسيرية، وصلت أحيانا إلى شطط السحرية في حلول التجميّل، وإنتهت بحلول الواقعية السحرية (على يد الكولومبي الكبير، غابريل غارسيا ماركيز) في تجميّل التفسيرات العصية على الهضم، والمدعوم منها بنصوص اكليروسية، على وجه الخصوص!
وإذا كانت بعض قداديس الكنيسة قد تخلت عن طقسها الكورالي فإن الرواية، ومنذ مطلع القرن العشرين على وجه الخصوص، كرست (طقسها الكورالي) كجزء من روحها الفنية والطرحية؛ بمعنى أن التفكير في العودة عن بعض علمية وحضارية الحياة لصالح (السعادة الحيوانية) صار من بين أهم محاور الرواية، رغم إختلاف وسائل التصوير والتعبير عنها بين كاتب وآخر.
ومن زاوية أخرى فإن حجم (طقس الرواية الكورالي) يقوم على مدى مساحة الوهم التي يعيش عليها الروائي ذاته، بإعتباره خالقا للنص، ومقدار إيمانه الشخصي بجدوى أو ضرورة (السعادة الحيوانية) كمعادل موضوعي لما جاءت عليه الحضارة الحديثة من مساحة حرية الإنسان في إختيار ما يشاء وما يناسب طقوس تقلباته الجوانية.. فالحيوانات في الغابة تتمتع بحريات تحسد عليها، فلم لا يتمتع الإنسان بمثلها وجده الأعلى كان من بينها، قبل أن يقف على قائمتيه الخلفيتين ويستخدم قائمتيه الأماميتين في أغراض أخرى، كان من المفروض أن تزيد من مساحة سعادته وحريته لا أن تصادر أجملها؟
وإذا كان إختراع الانسان للشعر هو أحد البدائل التعويضة عن تلك الخسارة، فإن إختراعه للرواية جاء لتسجيل وتوثيق ذلك الإختراع كصرخة إحتجاج، بإعتباره قد غبّن وخسر أكثر مما يستطيع تحمله من خسارة، كما قال الروائي الفرنسي، هنري باربوس (أشعر أني مخدوع ومغبون وغرر بي من جهة ما، وعليه أستحق تعويضا ما)!
وطبعا الانسان ـ الروائي والشاعر على الأقل ـ لا يبحث أو لا يؤمن بأن يكون ذلك التعويض ميتافيزيقيا مؤجلا، وإنما يريده أن يكون (كوراليا آنيا حاضرا صادحا!!) كي يتمم من خلاله (قداس) تجسيد إستعادة حريته: سعادته الحيوانية التي صادرتها الحضارة الحديثة بلا رحمة.
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني