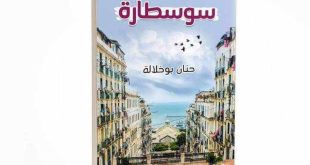قل له إني أحبه أرجوك!

الأديب والشاعر/سامي البدري / العراق
في مطار اتاتورك، مطار اسطنبول الرئيس، والذي لا احبه ولن أحبه يوما، لكثرة زحامه وضياعي فيه في كل مرة بسبب غياب ملامحه وملامح خارطته، تقدمت مني شابة عشرينية بخطى خجلة مترددة وهي تحمل نسختين من روايتي (إيقاع غريزة الفراشات) بيد مرتجفة لتقول: أنت مؤلف هذه الرواية… أود أن أشكرك اولا يا مجرم!، وبما أني كنت في اشد لحظات انزعاجي وتوتري لوجودي في مطار اتاتورك، الذي غالبا ما تأتي سفراتي عبره، بطريقة الترانزيت، وبساعات طويلة من إنتظار طائرتي الثانية، قلت في نفسي ها هي فرصة للخروج من ضيق تواجدي في مكان لا أحبه وإنتظار ست ساعات كاملة ستضيع هباء من زمني في إنتظار موعد طائرتي الثانية، فسألت الشابة وانا أتصنع اللامبالاة: هل هذا إطراء أم ذم؟ ردت علي بإستحياء: بل مدح لأنك فعلا صعقتني بإسلوبك وبما طرحت في روايتك… يا رجل أنا أسميت روايتك هذه النص الضائع لماركيز!… ولكنك فعلا كنت مجرما في معالجاتك وطريقة طرحك… هل تفهم ما أقصد؟
كان أجمل إطراء أسمعه فعلا لروايتي، من شابة لا تمتهن النقد الأدبي ولا يهمها من النص غير جمالياته ولحظات إستمتاعها به.. لم أشكرها على الإطراء بل سألتها كيف كنت مجرما في الطرح والمعالجة فقالت: أجدت فعلا في تشويق القارئ إلى الحد الذي جعلني غير قادرة على ترك الرواية، رغم ما سبب لي من نسيان لموعدين مع حبيبي وجعله يشك في حبي… تصور! قلت مداعبا: أما أنت تبالغين أو أنت لا تحبينه فعلا… وإلا كيف تسمحين لمجرد قصة خيالية ان تنسيك موعدا مع حبيبك وزوج المستقبل؟ إبتسمت هنا بدلال وقالت: هذا ما سببته أنت وعليك إصلاحه، وهذا هو طلبي الثاني.. فسألتها مداعبا: هل أنت جادة؟ أومأت برأسها بطريقة خجلة وهي تمص شفتها العليا وقالت: لن يكلفك الأمر أكثر من كتابة إهداء على روايتك… هل هذا كثير؟ قلت مداعبا: إن كان الأمر سيصلح ما أفسدت روايتي ما بينك وبين حبيبك فسأكتب إهدائين… فقاطعتني بلهفة: وهو ما أطمع أن تفعله فعلا لأن معي نسختين، الأولى نسختي الشخصية والثانية التي سأسترضي بها حبيبي بإهدائك.. قلت ممازحا وأنا أكتب الإهداء الأول: وماذا لو لم يسترضي إهدائي حبيبك… هل سأكون مجرمين أم ستكفين عن قراءة كتبي؟ إبتسمت ولم تقل شيئا، لأنها كانت مشغولة بفكرة ما وهي تراقبني وأنا أكتب إهداء النسخة الثانية.. وعندما أكملت كتابة الإهداء وهممت بتذيلله بتوقيعي صرخت بقلق كأنها تشاهد ثعبانا فجأة: لحظة هنا… أكتب له إني أحبه أرجوك… ستنفع العبارة كثيرا إن كتبتها بخط يدك.. قلت مداعبا: ولكني لا أعرف إن كنت تحبينه فعلا أم لا… ردت مماحكة وهي تغمز بعينها اليسرى: احسبها كذبة أخرى لتتم الرواية… كذبة خيال روائي ستكون بيضاء حتما وسيقبلها الجميع كما تقبلوا شطحات خيالك في الرواية!

كتبت للشابة ما طلبت ومضت به فرحة، كمن حصل على جواز سفر بعد عناء طويل، وعدت أنا لضجر الإنتظار في مطار اتاتورك الصحراوي الروح والجسد.. هو ليس اكثر من صالة طويلة مفتوحة على بوابات الخروج من وإلى سلالم الطائرات… وجميع موظفيه، رجالا ونساء، ضجرين ومتعبين ولا يرشدونك إلا إلى الإتجاه الخاطئ… إضافة لكونهم لا يجيدون غير اللغة التركية، التي يجيبون بها على لغتك الانكليزية بثقة زرافة صماء!
ندمت بعد مغادرة الشابة؛ ليس لأنها استهوتني، بل لأنها كانت ستخفف عني بعض مرارة الإنتظار في المطار… هذا المطار وأي مطار آخر، ليس لخوف بي من ركوب الطائرة، فأنا لا أخاف التحليق أبدا، إنما لثقل وعسف الإجراءات في المطارات… وكلها تأتي تحت يافطة السلامة.. أين الإهتمام بسلامة أعصابنا ومزاجنا ونحن نخضع لكل صنوف إجراءات التفتيش وعبوس الموظفين الضجرين والوجوه الحجرية لرجال الأمن؟
رغبت بإلتقاط صورة معي، تلك الحسناء العشرينية، ولم يمنعني ظهوري معها في صورة قصر تنورتها، لأني ببساطة غير متزوج وبلا رقيب اجتماعي.. لم يمنعني سوى أن أتصور معها وأنا بكل ذلك الضجر وتعكر المزاج… كنت سأبدو إلى جانبها بوجه رجل أمن عربي بلا أدنى شك، ممن يعج بهم مطاري بغداد ودمشق، وهما المطاران الأكثر رهبة بكثرة رجال الأمن فيهما؛ وكذلك هما المطاران اللذان أصادف فيهما أكبر عدد من الطيارين وهم ببزاتهم الرسمية التي يتباهون بأناقتها وسطوة رسميتها.. هل يفتقر هذان المطاران لمدخل خاص بالطيارين؟
مطار أتاتورك من أفقر مطارات العالم التي زرتها للمكتبات، والقليل المتوفر منها لا يبيع غير الكتب والصحف التركية.. لا أدري ما سر عداء تلك المكتبات للغات الأخرى.. ولكن، ورغم ذلك، أمضيت ثلاث ساعات من وقتي المضجر في الدوران على تلك المكتبات.. أين تلك الحسناء العشرينية؟ لم أعثر لها على أثر في اي من تلك المكتبات.. هل هي من مدمني الجلوس في المطاعم؟ لا احب ارتياد مطاعم المطارات ولا تكون بي شهية لتناول طعامها… وخاصة مع مقبلات ست ساعات من الإنتظار الممض.. زمنك آخر ما تفكر به شركات الطيران وما تلقي له بالا على أية حال.
اخيرا ظهرت رحلتي على لوحة الإرشاد الألكترونية وححدت لي اللوحة البوابة رقم (276 ) كمخرج من نفق ذلك الإنتظار.. ولكن أين تلك البوابة… لا يعرف مكانها لا نادلة المطعم ولا رجل الأمن… ولا حتى الشيطان، كما يقول الشاعر عبدالوهاب البياتي… وتهت وانا ابحث عن طريقها… وكادت الرحلة إلى دبي أن تفوتني لولا أن شابا لبنانيا خفيف الظل أمسك برسغي وقال اركض لم يعد غير خمس دقائق أمامك… تخيلوا ساعة كاملة من الضياع من أجل الإهتداء لبوابة في مطار الضياع وغياب التنظيم في اسطنبول.
كنت آخر ذيل الطابور لآخر تدقيق في تذكرة السفر ولا إبتسامة على وجه الموظف.. في كل مرة كنت أتمنى على موظف ذلك التدقيق أن يقول لي رحلة بلا عودة كي لا أعود لذلك المطار… ولكن حظي الجميل جدا مصر على إعادتي إليه في كل سفرة لي… ولإجراءات شركة تركش اير لاين… ووجبات طعامها الفقيرة ووجوه مضيفات طيرانها الأكثر ضجرا من وجوه موظفي مطار اتاتورك.. ولكن هذه المرة كانت المفاجأة التي قادتني إليها تذكرة سفري ورقم المقعد الذي سجل فيها… إنه كان بجوار الشابة العشرينية صاحبة الإهداء فقلت في سري: ارجو أن تنام كصاحبة ماركيز لتتحول إلى أميرة نائمة… عسى أن أتحول إلى ماركيز آخر.. لكنها لم تنم ولم تسكت… وأيضا لم تكن تحمل أشياء لترتبها، كما فعلت جميلة ماركيز… وفضلت على ذلك ان تقذفني بألف سؤال إلى أن وصلت للسؤال التالي: هل تخاف من التحليق في الجو؟ أومأت برأسي نافيا وأضفت: ولكني أفضل ركوب الباص تجنبا لإزعاجات إجراءات المطارات وشركات الطيران التي تقتل الكثير من زمني بلا وجه حق.. لا أخاف الطائرة لأني في كل مرة أركبها على أمل أن تصل بي لبوابة حلم ضائع أو إلى أرض بلا وجع وضجر المطارات وضرائب حضارة التكنلوجيا الحديثة وإغتيال رهاننا الوحيد، زمننا الذاتي، بلا رحمة، خدمة لمصالح شركات الطيران وسمعة امن المطارات. اومأت برأسها إيماءة غامضة دللت على أن كلامي ليس هو ما كانت تود سماعه من كاتب تطلعت للقائه، فأسلمت وجهها لهوة الفراغ التي كانت تحيط بالطائرة وصمتت… وصمت أنا الآخر… بإنتظار هبوط الطائرة في مطار من حلم… لا يشابه ما صادفت من جهامة المطارات السابقة في سفراتي.
هل ثمة مطار سيشذ عن القاعدة… ليكون مجرد محطة وصول لأحلامنا القادمة؟… بلا زحام، بلا جهامة موظفين، بلا توتر رجال أمن وصياحهم… وبصبايا لاهم لهن سوى أن يقلن (قل له إني أحبه أرجوك)؟
ثمة الاف من قواعد إطلاق الصواريخ والثكنات العسكرية والمراكز الأمنية والمطارات الحربية، التي تطير طائراتها لزرع الموت والدمار في المناطق البعيدة… لم لا يكون لنا بالمقابل مطار للقاء العاشقين وبوابات وصوله تقودنا للقاءات الأحلام؟ فمثلما كان الطيران حلما ذات يوم، ليكن اليوم محطة وصول أحلامنا المتبقية إلى محطة إستراحة من تمنينا على الأقل… بلا ضجيج، بلا زحام وإنتظار، بلا جهامة وجوه ضجرة وأعين مراقبة… وبلا إيقاظ مفزع من أحلام طيراننا للبعيد الذي نشتهي.
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني