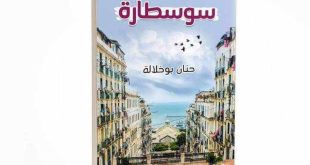الكاتبة بروين حبيب
شاعرة وباحثة أكاديمية وإعلامية بحرينية
مستقبل المكتبات
— القدس العربي/ الأثنين , 13 يناير , 2020
قلّما نقصد مكتبة حين نصاب بنوبة حزن، إذ نعتقد دائما أن الكتب وجبة للمعرفة لا طقسا للفرح، ويحدث حين تأخذنا أقدامنا بالصدفة إلى مكتبة، أن نقلّب بين الكتب، بحثا عن نتاج جديد، أو نتاج بعينه ينفعنا في بحث ما، أو يغذي موضوعنا المفضل للقراءة، هل نبحث عن شيء آخر؟
نقف أمام الرّفوف بحثا عن شيء نريده ولا نعرف تحديده، وكم نمتعض من بائع الكتب إن استشرناه، ولم نجد عنده جوابا شافيا. في المكتبة البائع يجب أن ينتشلنا من حيرتنا سريعا وإلاّ سنشعر بالإحباط.
جزء من تراجع القراءة في بلداننا يعود لذلك البائع البليد الذي ينقصه شغف الكتب وموهبة اكتساب الزبون، الذي لا يشبه زبائن المحلات التجارية الأخرى… لنقل أن هذه نقطة أولى، ولننظر إلى النقطة الثانية التي تذهب بنا في اتجاه مختلف، وهو اتجاه المكتبات العصرية في العالم، التي تسعى جاهدة لمنافسة العملاق أمازون، ومواقع بيع الكتاب الإلكتروني، والتوصيل المجاني إلى حيث تقيم. الاتجاه الذي جعل المكتبة اليوم «مكان التحديات الثقافية الكبرى» إذ ظهرت مكتبات تنظم ندوات، وحفلات بيع الكتاب بالإهداء، تلتها معارض للفن التشكيلي، وحفلات موسيقية، وتضع بعض المكتبات الأوروبية اليوم برامج لمؤتمرات أكاديمية جادة، كما تطلق سنويا جوائز أدبية مهمة.
نحت بعض المكتبات العربية هذا المنحى بشكل محتشم، كون جمهور الكتاب لم يتعوّد بعد على طقوس مماثلة، كإطلاق جوائز أدبية، رأت فيها الأغلبية خطوة غير واثقة، كون الجوائز ليست ذات قيمة مادية، ويبدو جليا أن ربط الجائزة بمبلغ كبير مفهوم ضيق لجائزة أدبية، فبعض الجوائز العالمية شحيحة في مكافآتها، لكنها ترفع من نسبة مبيعات الكتاب، غير التسويق الجيد للكاتب، ما يفتح له أبواب نجاح غير متوقعة، كالترجمة لعدة لغات، أو تحويل الكتاب لفيلم، أو غيرها من آفاق..
تذهب بعض المكتبات إلى خلق أقسام خاصة لأرشيف دائم للباحثين، تجمع فيه الكتب النادرة والمخطوطات الثمينة، ومنها الرسائل بخط اليد، لكتاب من زمن الورق والأقلام.
 هذا كله يندرج تحت عناوين عديدة، كتطوير المكتبة، لتصبح مكانا عاما يلتقي فيه المثقفون والكتّاب والقراء، أو لتصبح مركز إشعاع ثقافي حقيقي، أو ملتقى للفنون كلها، أو لنقل إنها عملية إنقاذ للمكتبة التقليدية، حين بدأ الكتاب الورقي يفقد قيمته، لكن السؤال الذي يطرح اليوم كسجال على نطاق واسع هو، هل يمكن للكتاب في خضم إدخال عناصر معه لتسويقها حفاظا على بقاء المكان أن يفقد قيمته؟ تأتي الأجوبة على اختلافها، بين موافق ومعارض، فالبعض يرى أن تسويق الكتاب وحده أنهك المكتبات، فأصبح من اللازم تسويق إكسسوارات مكملة لجماليات اقتناء كتاب، مثل نظارات النظر، و»البوك ماركرز» والنوّاصات الليلية الخاصة بالقراءة، والأقلام الضوئية، وحاملات أجهزة اللابتوب، وأشياء كثيرة يصعب اختصارها، ربما كانت من ابتكار أمازون وأصبحت اليوم تعج بها مكتبات كانت في الماضي لا تحتوي رفوفها سوى الكتب.
هذا كله يندرج تحت عناوين عديدة، كتطوير المكتبة، لتصبح مكانا عاما يلتقي فيه المثقفون والكتّاب والقراء، أو لتصبح مركز إشعاع ثقافي حقيقي، أو ملتقى للفنون كلها، أو لنقل إنها عملية إنقاذ للمكتبة التقليدية، حين بدأ الكتاب الورقي يفقد قيمته، لكن السؤال الذي يطرح اليوم كسجال على نطاق واسع هو، هل يمكن للكتاب في خضم إدخال عناصر معه لتسويقها حفاظا على بقاء المكان أن يفقد قيمته؟ تأتي الأجوبة على اختلافها، بين موافق ومعارض، فالبعض يرى أن تسويق الكتاب وحده أنهك المكتبات، فأصبح من اللازم تسويق إكسسوارات مكملة لجماليات اقتناء كتاب، مثل نظارات النظر، و»البوك ماركرز» والنوّاصات الليلية الخاصة بالقراءة، والأقلام الضوئية، وحاملات أجهزة اللابتوب، وأشياء كثيرة يصعب اختصارها، ربما كانت من ابتكار أمازون وأصبحت اليوم تعج بها مكتبات كانت في الماضي لا تحتوي رفوفها سوى الكتب.
فكرة الاستهلاك بشكل مختلف تنشأ اليوم بشكل متسارع، منذ دخل الكتاب بعض المقاهي وأصبح جزءا لا يتجزّأ منها، ولنتذكّر منذ سنوات فقط كانت الجريدة التي تقدم بدون مقابل للزبون، هدية عظيمة لها وقعها الجيد على نفسه، لكن اليوم بوجود الهواتف الذكية، أصبح الهدف إدخال بعض البهجة على قلبه بطريقة مغايرة للمألوف، فالمقاهي التي تقدّم السكر وقطعة البسكويت مجانا لا يبالي بها زبائنها، الذين يتركونها جانبا بدون استهلاكها منذ ارتفاع الوعي الغذائي، وإدراك مخاطر السكريات بكل أنواعها، إذن لنبتكر شيئا آخر، هكذا فكرت الفضاءات التي رأت في الكتاب مادّة جيدة لإغراء عشاق القراءة والكتابة والهدوء، للجوء إليها يوميا بحثا عن أجوائهم المفضلة.
دخول الكتاب إلى أماكن جديدة، لا يعني أبدا خروجه من مكانه الكلاسيكي القديم، فالمكتبة لاتزال مكانا مدهشا مع مرور الزمن، وتحضرني في هذا الشأن مكتبة القرويين في المغرب، التي أسستها ابنة تاجر تونسي، ورد اسمها في مواضع عدة، هي فاطمة الفهيري، مكتبة حركت قلبي من مكانه، كونها مكان فائق السحر، كما كل المكتبات القديمة التي احتضنت أمهات الكتب قبل مئات السنين، وامتلكت رهبتها الخاصة من وقار الكتاب وقوته. مثلها أيضا مكتبة الإسكندرية التي رغم ما لحق بها عبر العصور من تخريب ظلت رمزا لمكتبات العالم كله، إنّها أقدم بيت للكتاب، وكلما طالت ألسنة النّار محتوياتها نهضت مجددا لتحتضن كتبا جديدة، في محاولة غريبة لمحاربة خبث النار برقة الورق وسلميته.
يخرج الكتاب من أمكنته الخاصة به، لكنّه يدخل أماكن لا تخطر على بال، ليس من أجل تسويقه، بل هي سطوة الكتاب نفسه، يدخل الأسرّة، يشارك العشاق لذائذ نومهم ويقظتهم، يدخل المطابخ، يتربّع على طاولات الأكل، يغري الأطفال بالحكايات، يجذب الباحثين عن الحقيقة، يدخل الحقائب بكل أنواعها، الفاخرة الغالية الثمن، والبسيطة الخالية من أي أثر للثراء.. حتى في أتعس أيامه، وحده الكتاب يدغدغ الأدمغة الخلاّقة، بحثا عن طرقٍ جديدة لتسويقه، قام بالتسويق لأشياء أخرى معه، حاملا سلّة كرمه ليستفيد منه غيره، فأصبح رفيق الأشياء الجميلة، التي تزين الأماكن المُلهِمة.
لا يمكن للمكتبات اليوم أن تفقد وقارها، هذا شيء مؤكد، وهناك دوما ما ينقذها من الإفلاس، فقد بدأت مكتبات قديمة في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا بالعودة لنظام الاستعارة، مع قائمة من الأشياء التي يحتاجها الشخص لوقت قصير مثل، الخيم والأغراض الخاصة بالتخييم، مثل بعض أمتعة التزلج أو السفر، وهي أفكار قامت على فكرة ضيق الأمكنة لتخزينها، وتفادي إهدار مبالغ مالية كبيرة من أجل متعة مؤقتة، ابتُكِرت طرق التوفير هذه، لتنطلق من مكتبات تضم أجنحة متنوعة لكل ما يحتاجه المرء لتوسيع دوائر مُتعه الثقافية الخاصة.
لطالما اعتبر أصحاب القرار في الماضي أن الأنشطة الثقافية ليست من مهام المكتبة، فأُنشِئت قطاعات فكّكت جسد الثقافة، ما جعل الكتاب والأفلام والموسيقى كلٌّ في مكان منفصل عن الآخر، لهذا فإنّ ما يحدث اليوم هو عملية عكسية لكل ذلك، وكأننا أمام مشهد إحياء لموضة الأربعينيات مثلا، وإعادة إطلاقها اليوم بشكل مختلف كصرعة جديدة.
بين التّفكيك وإعادة البناء، يقف الجمهور أمام مفهوم جديد للمكتبة، على أنها مفهوم عام يحمل كل أشكال التعبير، كما يحمل المستقبل معه. نذكر جيدا خوف «الورّاقين» من الرّقمنة، إلى أن تحوّلت إلى طريقة لتسهيل أرشفة الكتب وطرق البحث والمراسلات وعمليات المحاسبة. دخلنا بعد تلك المرحلة عصرا جديدا يَعِدُ بتحوّلات جذرية، تقوم على بيانات هائلة بخوارزمياتها المعقدّة، وتطوّقنا من كل الجهات، وكأننا في منظومة تصنعنا ولم نعد نصنعها، ولعلّ هذا ما يثير رعبا حقيقيا في أعماقنا، ونحن ننسلخ شيئا فشيئا من كل المحسوسات، وحتى من أنفسنا لنتحوّل إلى خوارزميات نراها ولا نلمسها، فأصبحت الأمكنة التي تجمعنا وتحضن دفئنا البشري، مطمئنة لنا كوجود لا يهدده التلاشي. تلك المكتبات التي تبتكر وسائل للبقاء، ليست سوى أمكنة خاصة للإبقاء على ما يميز الجماعات البشرية المختلفة، بهويتها الثقافية، إنها «المعلم» الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، فوظائف المكتبة التي يقدمها لنا جهاز اللابتوب والإنترنت بنوعية سريعة لا تصنع المكتبة، كونها كما قال أحد المكتبيين « حصن عظيم ضد الانحطاط»، ومن خلال حضورها القوي وغيابها يمكن قياس أزمة المجتمعات ومكانتها على سلم التحضر.
٭ شاعرة وباحثة أكاديميةوإعلامية من البحرين
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني