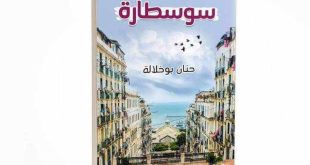هل مضى ذلك الزمن الموغل في التاريخ حيث القبيلة التي تحتفل بميلاد الذكر، ونبوغ الشاعر، ونتاج الفرس على ما ذكر ابن رشيق في “محاسنه”؟ أظن أنه ما زالت فينا بقية من ذلك التاريخ، كأنه بعض من “الجينات”. ربما تغيرت الظروف والحيثيات قليلا. لكن ثمة تجليات أخرى.
وأيضا، وقد عشنا دهرا لا نعد الثواني. هل مضى عهد الأحزاب والتنظيمات التي تحتضن الشاعر، وتشيد به، وتقيم له الأمسيات، وتجعله في صفوفها المتقدمة، متصدرا مشهدها السياسي والثقافي معا، ليكون لسان حالها في المحافل، حاملا أيديولوجيتها وفكرتها، فتنمو معه كثير من التفاصيل التي تؤطر الشاعر والكاتب ضمن هذا الإطار السيوثقافي المبهر، فيختلط المثقف بالسياسي ويصبحا عجينة واحدة، لها هدف واحد، إطعام الجماهير الجائعة حرية وثقافة وشعرا وسياسة.
ربما لم تعد التنظيمات، على كثرتها، تحتفل بميلاد الكتّاب والشعراء، بل ربما صارت تلك التنظيمات تخشى الكتّاب كثيرا، وتتهمهم بطول اللسان والجرأة وانعدام اللباقة، فتسارع إلى الضغط عليهم أو تهميشهم أو التبرؤ منهم بالكليّة، بفعل ما صارت عليه تلك التنظيمات من تدجين و”تسعير” و”نباحٍ” ضمن جوقة لا شعرية ولا سردية سوى سردية الراتب والمقرّ واستلام الحصة الشهرية من “السلطة” القائمة. لقد تراجعت تلك التنظيمات عن الدور التوعوي التي أقيمت من أجله، أو هكذا كان يشاع في عهد الرومانسية الثورية البائدة. ولذلك لم تعد تلك التنظيمات جماهيرية، ولا تعنى بالجماهير وقضايا “المد الثوري الشعبي”، لأنها ببساطة غدت بلا قضية حقيقية، واكتفت بالمحافظة على الأمين العام واللجان المركزية ومكاتبها السياسية التي ينتظر أعضاؤها منصب وزير عند تقاسم الحقائب الوزارية الخاوية من القيمة والاعتبار. وربما قنعت بيافطة تحمل اسمها تطل بخجل كقطعة ملابس بالية معلقة على حبل غسيل في الدور الثامن أو التاسع أو حتى الطابق الأول لعمارة مكتظة بكل شيء إلا بالوطن المكتظ بالوجع والانهيار والفساد والدكتاتورية المقيتة. هذا هو الوضع العام للقبيلة والحزبية في فلسطين هذه الأيام، والقادم أبشع وأكثر إيلاما، ولكن على ما يبدو تحن الأحزاب لبعض ماضيها والقبيلة لبعض مراميها.
كل ذلك لم يمنع الشاعر الجديد أن يعيش في ظل هذه “النوستالجيا” في حفل إطلاق ديوانه الأول، فقد أطلقه في عقر القرية في ديوان “العشيرة” العامر، حيث القهوة السادة والضيافة العربية، والحضور في أغلبه الأهل والأقارب والأحبة والأصدقاء، وقلّ الطيف الثقافي إلا ما كان محسوبا على دائرة من تلك الدوائر الأهلية المقربة.
كما لم يخل الحضور من الطيف الحزبي، ذلك الطيف الذي يخاف أن يبدو في العلن، فتوارى الحضور خلف الملامح التي جسدتها “اللحى” المزخرفة اللطيفة التي توحي وتقول أكثر من حاجة المرء للتصريح، فاكتسى أصحابها بالصمت الوقور والحبور المقدّس في حضرة الشعر والشاعر.
يفتتح الشاعر كلامه مقبلا رأس والده، رمزية فيها من المهابة والإجلال ما فيها، وفيها ما فيها أيضا من القبلية والاعتراف بالانتماء العشائري. يشكر الشاعر أهله وعشيرته كذلك الذين ساندوه وشاركوه هذه الفرحة؛ يتجسد المشهد الذهني الذي أعرفه تصورا مكتوبا عن الشاعر القديم، بما يشبه مثلا حفلات “ختان” الأطفال الذكور في القرى الفلسطينية أوائل الثمانينيات. مشهد القبيلة وهي تحتفي بميلاد الشاعر الجاهلي الفحل الذي سيذود عن القبيلة وأعراضها، ليكون كلامه أوقع على الأعداء من وقع السهام في قلوبهم.
وفي السياق ذاته وعلى قدم المساواة الذهنية والارتفاع الرمزي للمشهد، يبدو الحزب أو التنظيم وهو يعلن في الخفاء عن تبنيه الشاعر “المقاوم” والمثقف المنتمي، ولو كان هذا الاحتفال بـ”التقية”، تبعا للظروف إلا أنه سيشكل سندا ثقافيا قويا لهذا الحزب في الساحة الثقافية، لعل الظروف تتبدّل، فالعناصر الثقافية جاهزة وستكون في موقعها المخطط لها أن تكون فيه.
هذه المشهدية الحزبية والقبلية لم ينج الشعر منها أيضا، فقد تجلت أولا في اقتسام الشعر في دوائر ثلاث، احتلت القرية الصدارة ثم المدينة ثم تأتي فلسطين التي تراجعت إلى المرتبة الأخيرة في الاهتمام، هل يعني ذلك منطقيّة ما؟ صغرت أحلامنا أم ارتدّت إلى عقلية جاهلية بعيدة الغور؟ هل يعني ما عناه القرآن الكريم “أولى لك فأولى”؟ والأوْلى هي القرية موطن الأهل والعشيرة. وتجلت ثانيا في شعر الشهداء والفقراء والأم الثكلى والراحلين من الأصدقاء، والحبيبة المختفية التي خلفت طيفها وحنينها في ظلال القصائد، فظلت تلوح بخجل بين السطور. موضوعات وصور أدبية وإيقاع شعري يحيل السامع المحتفل على ذلك التاريخ القابع في الرأس ويأبى أن يحتّ ما تبقى من صدئه وصداه.
وللإلقاء مشهده الخاص أيضا، فمشهد الشاعر وهو يلقي قصائده يذكّر بمشهد الشاعر الذي كان يقف منشدا، رافعا صوته، مستدرا أكف الحاضرين لتمطره بالتصفيق كلما قال بيتا أو مقطوعة، كأن هناك شبه تواطئ على أن يقول الشاعرُ وأن يصفّق الحضور، فينتشي الشاعر، ويعيش لحظة الزهو كما ينبغي لشاعر فحل ينشد في عكاظ أو ذي المجنة أو ذي المجاز، مع فارق يبدو جديرا بالملاحظة هو أن هناك من الحضور مَنْ لم يكن يدري ماذا يقول الشاعر ولم يفقه معانيه، لكنه كان يصفق أكثر من الذين كانوا يدركون معنى الشعر، ربما أراد أن يُدخل نفسه في السياق مع الآخرين، ويُريهم أنه يسمع ويرى ويفهم، مثلهم تماما إذا لم يكن أكثر منهم.
كل تلك “المشهديات” تنبئ أننا ما زلنا “هناك”، حيث الشاعر الجاهلي وقبيلته، ولكن لا بأس، فالشعر ربح شاعرا جديدا. فإن ودع الشعر والشعراء شاعرا في مواكب الموت، فإنه مع كل شاعر يرحل، يولد شاعر جديد في مكان ما على ضفة النهر، فيضحي الشعر مودّعا شاعرا عاش في فضاء غير شعري، ومستقبلا شاعرا “نبغ” في هذا الفضاء غير الشعري أيضا، ربما يأتي يوم ويقول أبعد مما قال، وإن اتكأ على القبيلة وأطياف حزب ينام في الخلايا الساكنة، لعله يصحو يوما، مع أنه لم تنم يوما قبائل الشعراء القدامي والمعاصرين وأحزابهم التي يعاودها الحنين لماضٍ مات، بل شبع موتا وتحلّلت جثته بفعل بكتيريا السياسة وفيروسات المال والفساد والرجعية البائسة، وكلما مات شاعر وولد آخر، يظل السؤال قائما: “أين الشعر من كل هذا الذي يحدث لنا؟”.
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني