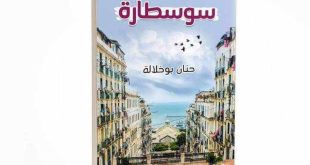إشكاليّة المنفى والعودة في رواية “القادم من القيامة” لوليد الشّرفا

“القادم من القيامة” هي العمل الثّاني الّذي أقرأه للرّوائي د. وليد الشّرفا أستاذ الإعلام والدّراسات الثقافيّة في جامعة بيرزيت، فمنذ ما يزيد عن عشرين عاما كنت قرأت عمله الأوّل المسرحيّ “محكمة الشّعب”. صدرت الرّواية عن المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر في بيروت عام 2013، وتقع في (174) صفحة من الحجم المتوسط. وسبق أن أصدر عام 1994 نصّه السّرديّ الثّاني “اعترافات غائب”، ثم كتابا بعنوان “الجزيرة والإخوان: من سلطة الخطاب الى خطاب السّلطة”، كما أصدر مؤخّرا رواية “وارث الشّواهد” عن دار الأهليّة في عمان، عدا أطروحتين جامعيّتين الأولى حول “بواكير السّردية العربيّة”، والأخرى “تحليل الخطاب في أعمال إدورد سعيد”.
تمتاز رواية “القادم من القيامة” بانتهاجها أسلوبا تجريبيّا يفارق كلاسيكيّة البناء في الرّواية الفلسطينيّة، وإن بقيت تطرح الأسئلة ذاتها السّياسيّة المعهودة في السّرد الفلسطينيّ الّذي يتناول القضيّة الفلسطينيّة، ولكن باتّصال مع مسائل فلسفيّة وثقافيّة، تفرض نفسها على المثقّف ليناقشها من وجهة نظره، فيودعها الفنّ الرّوائيّ.
تطرح الرّواية إشكاليّة المنفى والخروج من الوطن والعودة إليه في ظروف غير طبيعيّة، كما كان الخروج غير طبيعيّ، وهذه إشكاليّة تحوّلت إلى ثيمة إبداعيّة عند كثير من الأدباء الفلسطينيّين، بدأها ربما الشّاعر محمود درويش في أشعاره المبكّرة، عندما قال:
“وأبي قال مرّة:
الّذي ما له وطن
ما له في الثّرى ضريح
ونهاني عن السّفرْ” (المجلّد الأوّل، قصيدة أبي، (ص140)
وتكرّرت بعد ذلك عند غيره من الأدباء من شعراء وروائيّين، وسبق للنّاقد عادل الأسطة أن ناقشها، في مقالة له نشرت في صحيفة الأيّام (26/11/2017)، وأتى على كثير من الأعمال الأدبيّة الّتي طرحت شعار “هنا باقون”. وفي هذه الرّواية ثمّة ساردان؛ منفيّ ومقيم، يتنازعان نظرتين مختلفتين، أحدهما يأبى الخروج من الوطن مهما تردّت أحواله، والآخر ينعم نعيما زائفا بالمال والنّساء وتأسيس الشّركات والغوص في أحضان بلد وحضارة كانت سببا في شقائه، ليبدو فردا ناجحا ضمن سياق النّظام الرّأسماليّ الّذي وفّر له كلّ أسباب العيش بحرّيّة.

في “القادم من القيامة” ثمّة صوتان روائيّان يتناوبان السّرد بضمير “أنا”، وأحيانا يتداخلان، فيصعب تحديد أحدهما، إذ تعمّد الكاتب هذا التّداخل، وهما يقصّان حكاية الوطن، وما آلت إليه أوضاعه بعد فشل الثّورات الفلسطينيّة، وربّما فشل المشروع الوطنيّ برمّته من أن يحقّق غاياته المرجوّة، وتحوّل إلى وطن من ورق على الورق، بألقاب زائفة ليس فيها معنى للكرامة الوطنيّة، بلد، كما تقول الرّواية،: “كلّها عايشة بالسّرقة والشّحدة” (ص141)، بل أبعد من ذلك، فــ “نحن نموذج فريد من صناعة الهزيمة” (ص142)، ونتصارع ونهرول من أجل كيس من الطّحين. وطن تحوّل فيه الجميع إلى فقراء، وأصبح ثوريّو الأمس هم المستغلّين واللّصوص.
تلوذ البنية الرّوائيّة الّتي تقترب من “الفنتازيا” والغرائبيّة بعدّة وسائل لتحقيق دراميّتها، للكشف عن لا واقعيّة الحاضر المأزوم؛ بدءا باللّغة الّتي تجنح إلى العبارات القصيرة، والتّقطيع السّينمائيّ للمشاهد الرّوائيّة، وانتقالها من جغرافيا إلى أخرى دون أن تشير إلى ذلك، وكأنّ كلّ الأمكنة أصبحت مكانا واحدا؛ لا فرق بين المنفى والوطن، وتلجأ الرّواية إلى توظيف الرّسائل والحلم، باعتبار الحلم إحدى وسائل الغرائبيّة، القائمة على توقّع الكارثة قبل حدوثها، ممّا يجعل البناء الرّوائيّ مكثّفا يحيل القارئ إلى نظريات التّحليل الاجتماعيّ والسّياسيّ والدّراسات الثّقافيّة، وحتّى النّفسيّة؛ لتأويل هذه الحالة الملتبسة و”الفريدة” الّتي وصلت إليها الشّخصيّات الرّوائيّة بوصفها معادلا موضوعيّا يحيل إلى واقع مأزوم.
ما يلفت النّظر أيضا في هذه الرّواية أنّها قائمة على تنميط الشّخصياّت قصدا، فلا أسماء، ولا أوصاف لها، إلّا ما ندر، فليس هناك أسماء للسّاردَيْن البطلين في الرّواية، ولا لصديقهم الشّهيد الموصوف في الرّواية أوّلا بصفة “الشّيخ”، ثم يتحوّل إلى “الشّهيد” ولا لـ “الشّاعر” المستغلّ الانتهازيّ المشكوك بثوريّته وإخلاصه، وكذلك شيخ الجامع. عدا شخصيّتين الأولى هي “عائشة” زوجة الشّهيد و”الكامل”، وفي هذا التنميط للشخصيات يجعلها أكثر قدرة على حمل الفكرة المراد لها أن تحمل قضية شائكة وصل إليها الوطن الّذي غدا حالة فريدة من الضياع والجنون أيضا، وليس فقط حالة “فريدة من الهزيمة”.
لعلّ شخصيّة “الشّاعر” وما يتّصل بها من أفكار أكثر ما يسترعي الانتباه، وقد اتّفق السّاردان على وصف ذلك الشّاعر بالبشاعة والسّوء، ليتّضح من خلال الحديث عنه، أنّه شخصية تفارق طبيعة الشّعر، وما يجب أن يكون عليه “الشّاعر” من صفاء ونقاء، هذه الشّخصية الّتي تحمل مفارقة بليغة، لها دلالتها النّصيّة، فقد بدا السّارد المنفيّ ضد هذا الشّاعر يقول: “كان صديقنا يكره الشّعر لأجله، وكان يردّد: لا أدري ما الفائدة من كلام يكتبه في الغالب أناس مرضى تافهون يريدون من النّاس احترام شذوذهم. كان يقول وماذا يعني ذلك، كلّ الكلام الموزون هذا لا يكفي لإطعام عصفور” (ص29). يبدو أنّ هذا الكلام ينمّ عن واقعيّة ما بعيدا عن ارتباط الحديث بالشّاعر المذموم هنا، إنّ مضمونه يعود مرّة أخرى ليبرز على لسان المرأة الفرنسيّة الّتي رأت خلال حوارها مع السّارد المنفيّ: “أنتم هكذا تخلقون شعراء، أكثر من عشر سنوات لم تمح منك هذه البلد أصلك”، وتوضّح قولها: “تحبون الشّعر والمبالغات” (ص118).

إنّ ما طرحه المتن الرّوائيّ من النّظر إلى الشّاعر يعود إلى مناقشة عميقة، مختلفة، ما بين ثقافتين وحضارتين وعقليّتين، وكأنّ السّارد الّذي يفصح عن امتلاكه “لغتهم” ونمط تفكيرهم بوصفهم آخر محتلفين عنه، ما زال ينتمي إلى ثقافة تحبّ المبالغة والشّعر، والبعد عن العقلانيّة والتّفكير المنطقيّ، كما أنّ فيه انحيازا واضحا للغة السّرد الّتي هي بالضّرورة، سياقيّا وواقعيّا، لغة قائمة على العقل والمنطق، ولا تجنح إلى الخيال والمبالغات. وكأنّ مصيبتنا الحضاريّة هي في الشّعر وقوله بوصفه نسقا ثقافيّا مسؤولا عمّا نحن فيه من تردٍّ وتخلّف، كما يقرّر ذلك النّاقد السّعودي عبد الله محمّد الغَذّامي في كتابه “النّقد الثقافيّ”، فيرى أنّ الثّقافة العربيّة تمتاز بعدّة مظاهر نسقيّة أهمّها كما يقول: “تغييب العقل وتغليب الوجدان، وهذه أخطر الحيل البلاغيّة والشّعريّة، وجرى عبرها تمرير أشياء كثيرة لمصلحة التّفكير اللّاعقلاني في ثقافتنا، وفي تغليب الجانب الانفعاليّ” (النّقد الثقافيّ، الغذّامي، ص83).
هذه النّظرة للشّعر اختلفت في الفصل الأخير من الرّواية لتصبح مغايرة تماما لهذه الصّورة، فيلوذ السّارد إلى الشّعر، ويطلبه، ويتمنّى لو كان شاعرا: “آه آه، أين الشّعر الآن؟ آه لو كنت شاعرا يا صديقي، لأنشدتك على مسامع الكون، وجعلت جسدك استعارة للحياة من الموت”. (ص167). بل إنّه يرى في “الشّعر شاهدنا المطلق على إنسانيّتنا”. فهل تراجع السّارد عن موقفه ضدّ الشّعر والانحياز للعقلانيّة أم أنّه كان مأخوذا بثقل اللّحظة الوجدانيّة الّتي كان يراها أمامه صارخة، حيث صديقه المضرّج بدمائه؟ إنّها ربّما حالة لا ينفع فيها غير الشّعر والالتجاء له، فهي حادثة “لا بدّ أن تتحوّل إلى شعر لتخلد” (ص166).
على الرّغم من أنّ المتن الرّوائيّ قائم على مفارقة أكبر من ذلك، فالسّارد المنفيّ يكثر من الاستشهاد بالشّعر، ويبرز في لغته أنّ ثقافته شعريّة في جانب كبير منها، ما يعزز انتماءه إلى بلد وحضارة تعشق الشّعر والمبالغات، بل إنّها بلد/ وطن فرضت عليه الظّروف أن يظلّ خياليّا شاعريّا يعيش الشّعر ويصنعه، لعلّه بذلك يستطيع قهر كلّ عوامل التّخلف والتّردّي أو على أقلّ تقدير التّصالح مع هذا الواقع، ما يشكّل نوعا من الهروب نحو اللّامعقول تجنّبا للمصادمة مع واقع مرير لا يستطيع أن يفعل فيه شيئا.
لقد بدت الشّخصيّات بالمجمل أيضا شخصيّات مأزومة تعاني من صراع الذّات أوّلا، والصّراع مع الآخر ثانيا، وصراعا مع الوجود كذلك، فثمّة أزمة في حياة الشّخصيّتين الرّئيسيّتين السّاردين، فالسّارد المنفيّ يعاني من أزمة حضاريّة استشعرها خلال وجوده في بلاد الغرب، وظهر ذلك من خلال حواره مع صديقته الفرنسيّة، كما أنّه يعيش أزمة نفسيّة وصراعا ذاتيّا نتيجة فشله في الحبّ مع “ياسمين” الفتاة الّتي أحبها في “بلاد الأنبياء”، فرأى كلّ النّساء هناك حيث يقيم، نسخا لأصل ضاع منه، كما أنّ السّارد الثّاني صديقه المقيم في الوطن يعاني من أزمة وصراع ذاتيّ مرير جرّاء ما يشاهده وما يعيشه “هنا”، ولكنّ ثمّة فارقا بينهما، فصديقه المقيم ينهي صراعه بطريقته؛ فيستقيل من عمله، موضّحا سبب تلك الاستقالة بقوله: “إنّني وبعد سنوات من خدمة الوزارة وجدت أنّني أمارس دورا مزدوجا في تعميق حالة التّراجع والفساد، لأنّنا نقوم بدور شاهد الزّور، لأنّنا لسنا وزارة ولا نملك أيّ قرار”. (ص159)
إنّها مسألة تحيل إلى وعي متقدّم لدى هذه الشّخصيّة الّتي وصلت إلى مرحلة مساءلة الذّات واتّخاذ قرارها الأخير حتّى لا تكون “شاهد زور” على قضية كبرى كالقضية الفلسطينيّة، وهو يرى الفساد يمخر في جسد الوطن، ويتجرّعه المواطن ذلّا يوميّا.
لقد استعان الرّوائيّ وليد الشّرفا في هذه الرّواية بمخزونه الثقافيّ المتنوّع والمفتوح على ثقافات متعدّدة، بدءا بالنّصّ الدّينيّ واستحضاره على لسان شخصيّاته، محاولا فضح السّلوكيّات البشريّة المتمترسة خلف المقولات الدّينيّة، ومنها تبرير “عائشة” لزواجها من “الشّاعر”، وتبرير أفعال شيخ المسجد الّذي كان يزور بنات الشّيخ المتوفى متذرّعا بالصّدقة الخفيّة.
وحضر في المتن الرّوائيّ كثير من المقاطع لأغانٍ شعبيّة فلسطينيّة، ومقاطع لأمّ كلثوم وفيروز وبعض من مقولات الشّاعر محمود درويش، والمتنبّي، وظلال من معلّقة طرفة بن العبد، ونزار قبّاني، وخاصّة قصيدة “قارئة الفنجان” مغنّاة، معيدا في مواقع متعدّدة هذه الجملة “وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان”، وهذا ما تحقّق في نهاية الرّواية؛ حيث كانت عودة السّارد المنفيّ حزينا فاقدا لصديق طفولته، لقد عاد “مهزوما مكسور الوجدان” حقا.
كما لم تتخلّص الرّواية من أفكار النّاقد الفلسطينيّ إدوارد سعيد، لا سيّما في مقولاته حول الاستعمار والإمبرياليّة ونظرة الغرب للشّرق، وقد برز ذلك واضحا في حوار السّارد المنفيّ لصديقته الفرنسيّة، وبدا حواره معها مسترسلا عكس بقيّة الحوارات في الرّواية الّتي جاءت مقتضبة وقصيرة، وتنتهي على عجل. استهلك هذا الحوار عدة صفحات (151-156)، وفيه مناقشات فكريّة تشير إلى المقولات الّتي طرحها النّاقد سعيد في كتبه. عدا ذلك ما يلاحظه القارئ من ظلال لروايات أخرى، وأهمّها رواية “موسم الهجرة إلى الشّمال” للطّيب صالح وقضية البطل الإشكاليّ “مصطفى سعيد” الّذي التقى مع السّارد المنفيّ في جوانب كثيرة، لعلّ أبرزها إقامة علاقات نسائيّة كثيرة، مع أنّ السّارد في “القادم من القيامة” كان سلوكه ردّ فعل تعويضيّ على خسارته لحبيبته “ياسمين”، أمّا “مصطفى سعيد” فكان سلوكا انتقاميّا على طريقته من الاستعمار البريطانيّ. كما يلمح القارئ تأثّرا بغسّان كنفاني وروايته “رجال في الشّمس”، وخاصّة في المشهد الّذي تظهر فيه السّاعة، فقد أخذ السّارد المنفيّ ساعة صديقه الشّيخ، حيث كان حاضر عند استشهاده، كما أنّ “أبا الخيزران” قد استولى على ساعة “مروان” أحد الثّلاثة الّذين قضوا نحبهم في رحلة التّهريب. ثمّة إشارة خفيّة هنا إلى الخيانة، فليس أعظم من أن يخون الثّائر وطنه ويهرب بعيدا، باحثا عن مجد شخصيّ، وهذه فكرة رواية غسان كنفاني أيضا، ولكن هيهات له أن يجد راحته، إن الاستيلاء على السّاعة، ربّما دلالة تشير إلى مصادرة الوقت، وتحوّله من مرحلة إلى أخرى، كأنّ أخذ ساعة الشّهيد مصادرة لزمانه، فلم يعد موجودا.
تزخر هذه الرّواية بالكثير من الدّلالات الّتي تستدعي الوقوف والإشارة إليها، لعلّني أفلحت في مناقشة بعضها في هذه الوقفة الّتي لن تغني عن قراءة الرّواية بكلّ تأكيد، بل ربّما ستدفع القارئ إلى الاشتباك مع مقولاتها، والاسترسال مع حكايتها كشاهد حيّ على وطن يضيع بلا هوادة ولا رحمة، حتّى لا نتحوّل جميعنا كتّابا وقرّاء ومثقّفين إلى شهّاد زور.
 صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني